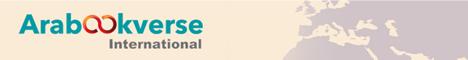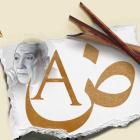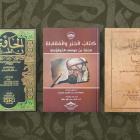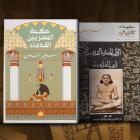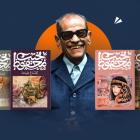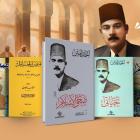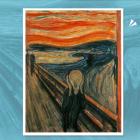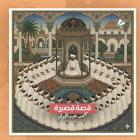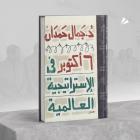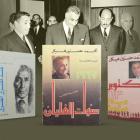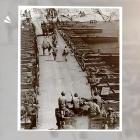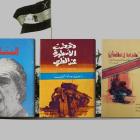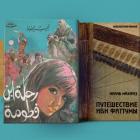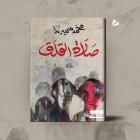وبهذا المنظور، يمكن القول إن الثورة، أي التعجيل بالتغيير عنوة، سمة ملازمة لحياة الجماعات البشرية التي تتطلع إلى الأفضل، وأن تلك السمة باتت – في هذا العصر – أشبه بطريقة حياة لأهله.
ومع ذلك، فإن قراءة تواريخ الثورات بأعينٍ مفتوحة، وتتبع ما تتحول إليه الثورة بعد أن تنتصر وتتربع مكان خصومها القدامى، لا بدّ أن يثير في الذهن – ما لم يطمسه الأضواء أو يعطّله الارتزاق – تساؤلًا جوهريًا هو: في كل هذه الثورات، مَن الذي يثور من أجل مَن؟
هناك في التاريخ ثورات تركت بصماتها على مصائر شعوب بأسرها، وورثها العالم من الشعوب التي وقعت تلك الثورات داخل حدودها، كالثورة الفرنسية، والثورة الأمريكية، والثورة الروسية، والثورة الصينية.
لكن ضخامة الأثر الذي أحدثته تلك الثورات لم يُلغِ – في أي وقت – التساؤل المشروع فيما يخص الثورات جميعًا، وهو: لمَ ظلت الثورات دائمًا ثورات بالوكالة؟ ولا يُلغي أيضًا مشروعية التساؤل: ولمَ كانت تلك الوكالة – في الكثير من الحالات الفاجعة – مزورة؟
فالواقع، الذي قد لا يجد كثيرون القدر الكافي من المكابرة لإنكاره أو التعامي عنه، هو أن الثورة نُسبت – المرة تلو المرة، وبخاصة في العالم الثالث – إلى الجماهير والشعوب، بينما التي تُفجّرها وتغنم البلدان من خلالها، فئات أو عصابات ذات مصالح.
نعم، لا تكف الكتب الملتزمة بتلك المصالح، والمراجع التي تُخرجها مطابع تلك الفئات، وأجهزة الإعلام التي تديرها، عن التحدث عن ذلك الكيان المبهم المدعو بـ«الجماهير الكادحة» – أي غير الموسرين – والشعوب المغلوبة على أمرها، والملايين المُستَغَلّة (بفتح اللام)، والتواري وراء كل تلك الأعداد الكبيرة من البشر، والتغني بحقوقها وآمالها ومصالحها بوله، وورع، وتقوى ما بعدها تقوى. لكن الذي يحدث – فيما عاينّاه بعالمنا – أنه باسم تلك الحشود كبيرة العدد، تُطلق الشرارة وتحدث الانفجار جماعة، أو فئة، أو طغمة، أو عصابة (أو – باللفظة المتوقرة المعتمدة – تنظيم)، أو حزب، فتكون قيادة الطغمة أو رئاسة الحزب هي صاحبة الثورة حقيقة وواقعًا.
حتى وإن تمكّنت أجهزة الإعلام والتعمية والتبهيم بالديماغوجية، والغوغائية، وسَوق الحشود كثيرة العدد كما تُساق القطعان، وجعلها تعوي أو تخور تبعًا لمقتضيات الحال، ومن أن تزحم الشوارع، والساحات، والميادين، وشرفات المنازل، والكيلومترات العديدة الممتدة على جوانب السكك الحديدية، بمئات الألوف من تلك الملايين الجماهير، أو حشود الوحدات الرقمية الضائعة المغمورة التي لا يُقيم أحد – في حقيقة الأمر – أي وزن إلا لإمكانيات استخدام كثرتها عالية الصوت، بالحوار أو العواء، للتضليل والتعمية عما هو حادث حقيقة، وجعلها – في الوقت ذاته – تسكر بصخبها ذاك لتذهل أكثر فأكثر، وتعمى أكثر فأكثر، عمّا تُعدّه الطغمة الثائرة لها ولبلدها المسكين.
وبينما تلك الملايين الكادحة المبجلة، القابلة للاستهلاك والاستبدال، عديمة الوجوه، تصيح وتهتف وتحطم وتحرق، لتنفّس عمّا يغلي بصدورها من ضيق بالمظالم، وما تعانيه من قهر واستعباد وفقر، (فيُقال: والله! الشعب قام، ما أروعه! الشارع ثار، ما أعظمه!)، بينما تلك الملايين البكماء – رغم الخوار والعواء – تعيش بالطول والعرض والعمق لحظة ذلك «الانتصار» الذي تتوهّمه، موهومةً بأنها – في تلك اللحظة القصيرة من الصياح والتحطيم، وربما القتل والولغ في الدماء – قد تواجدت أخيرًا بعد طول غياب، وبانت كائنةً حقًا، ومتحكمة في مصائرها (أو – كما يقول لها «الثوار» الأمجاد – متحكمة في مقدَّراتها).
وربما – من فرط انتشاء بالتواجد والحضور – أنشبت أنيابها في أعناق بعضها البعض كأعناق أعدائها سواء بسواء.
تكون الفئة أو الطغمة التي أطلقت شرارة كل ذلك، وأحدثت الانفجار، قد حققت الهدف الذي أطلقت تلك الملايين للوصول إليه، واستتبّ لها الأمر، بعد أن تخلصت – بفضل هياج الجماهير «الكادحة» – من منافسيها القدامى الذين كانوا ممسكين بزمام السلطة، فباتت هي الآن صاحبة الحق في المحافظة على الأمن، والقانون، والنظام.
وإذ ذاك، يُصدر بيان «ثوري» يُكتب عادة بعبارات إنشائية رنانةٍ طنانة، طافحة بذلك الشيء الفظيع الذي أُطلق عليه وقتًا اسم «المجد والخلود»، تُشيد فيه الطغمة المنتصرة بما حققه الشعب الثائر العظيم من منجزات، وتدعو فيه الرفاق المواطنين، أو زملاء الكفاح، أن يتفضلوا الآن مشكورين بالعودة إلى سابق عهدهم من استكانةٍ ولوذٍ بالشقوق، فيلزموا الهدوء، ويخلدوا إلى السكينة والنظام وحسن الأدب، ويعود كل ابن آدم منهم، والفخر ملء أعطافه (ألم يَثُر وينتصر؟) إلى موقع عمله (أو موقع بطالته، تبعًا لمقتضى الحال)، ويقرّ عينًا، بعد أن استرد حريته وحقوقه المسلوبة، وبات البلد بلده بعد أن كان بلد أولئك الأشرار الذين أطاحت الثورة المجيدة بهم، بفضل بطولته الكفاحية وضراوته النضالية، ويترك الأمور في الأيدي الأمينة التي أمسكت بها، فيدع الثوار الأبرار الطيبين الأخيار يعملون في هدوء بغير إزعاج، ليقوموا بالواجب خير قيام في خدمة الوطن المفدى، و«السادة» المواطنين.
وهنا تزحف تلك الحية المشؤومة فتطل برأسها القبيح – و«الأجيال القادمة» بإذن الله، أو بإذن التاريخ، إذا كانت الثورة المجيدة عندما تُسرق قد وقعت في بلد ليس شديد التدين – وفي ختام البيان الثوري، تُسفر الطغمة الثائرة عن وجهها قليلًا، فتورد تحذيرًا للسادة المواطنين بأن من لم يخلد منهم إلى الهدوء والنظام ويترك الأمر في يد أولي الأمر الجدد، سيحدث له ما لا تُحمد عقباه؛ لأنه – بعدم إخلاده إلى الهدوء والنظام – سيُعطّل مسيرة التاريخ إلى تحقيق مصالح الأجيال القادمة.
ولا يوجد عقل أو ضمير يمكن أن ينكر أن الاستعباد، والفقر، والظلم، أشياء قبيحة منافية للإنسانية، تُشعل نيران النقمة والرغبة في التغيير في صدور من يعانونها، وإلا فإنهم لا يكونون بشرًا. لكن العقل والضمير ينبغي أن يلاحظا أيضًا أن حكاية الشعب الثائر هذه، أسطورة. وإن طبيعة المجتمعات وتنظيمها يجعلان من المحتم أن تتقدم جماعة، أو فئة، أو طليعة، أو طغمة، لتمسك بالزمام، وتُفجّر، وتُقود، وتستقر بعد ذلك وتترسخ. وإن الثورات تُسرق أحيانًا من أصحابها المظلومين المستعبَدين، أليس كذلك؟ ذلك ممكن، وقد حدث في بلدان كثيرة، أليس كذلك؟
وعندما تُسرق تلك الثورات من أصحابها، ألا تتحول الثورة، أحيانًا، إلى احتلال داخلي للبلد، واستعباد أفظع لأهله المظلومين الذين وقعت الثورة باسمهم؟ مهما كانت القوانين الموضوعية، والضرورات التاريخية، وكل تلك الأشياء المهولة، ألا تُسرق الثورات؟
وفي مواجهة هذا الواقع الكريه، ما الذي ينبغي للأدب أن يفعله؟ بوسع الأدب طبعًا أن «يلتزم»، كما حدث في مصر بعد ١٩٥٢، ويأمل، ويدافع، ويطالب بوقت. وبوسعه أيضًا أن يتساءل: «بأي حق؟» يرفض، ويقاوم، ويحاول كشف الخديعة وتعرية الأكاذيب. بوسعه أن يصرخ بالصوت العالي: الثورة، نعم، «ولكن من أجل مَن؟»، وهو يرى رأي العين الطغمة المسلحة تتحول إلى نظام حكم، وتتدهور إلى جيش احتلال داخلي يعامل بلده كما لو كان غنيمة حرب، ويتعامل مع الشعب الكادح كما لو كان ذلك الشعب المنكوب هو العدو، وهو الهدف، ويرى «الثوار الأبرار» يتحولون إلى كتلة حجرية صلدة من مؤسسات ذات مصالح ترتكب من المظالم، وضروب القهر، والبغي، والاستعباد، والنهب، ما يجعل الأدب ملتزمًا بالدعوة إلى الثورة عليها واستئصالها من جسد البلد المسكين، كما يُستأصل الورم الخبيث.
وبوسع الأدب أيضًا أن ينتمي، ويرتزق، ويسير في الركاب، ويأخذ له نصيبًا من الأسلاب، ويكذب، ويكذب، ويكذب، حتى يحتقن وجهه القبيح، ويسوّد من فرط الكذب، فيتحول إلى عبدٍ ومطية.
من أجل مَن تقع الثورات؟
من أجل الحشود العميمة التي يكثر الكلام عنها في البداية؟ من أجل الكثرة الكثيرة، والسواد الذي هو الأعظم، الذي تستغله وتطحنه وتمضغه القلة القليلة التي لا تزيد عن ماذا؟ واحد بالمائة؟ نصف بالمائة؟ ربع بالمائة من مجموع الشعب؟
والذي لا خلاف عليه، أن القلة القليلة تُفجّر، وتستغل الكثرة وتطحنها، وفي العالم الثالث بالذات – نظرًا لعِظَم الفجوة التي تفصل بين القلة والكثرة من حيث: المزايا الموروثة، ومستويات التعليم، وإمكانيات التربّح من وراء الوضع الاجتماعي، وانتفاء العدالة في مجال التمثيل في هيكل السلطة – يكون ذلك الاستغلال بشعًا وكريهًا لا يقبله عقل أو ضمير، بل وترفضه حتى رجاحة العقل العادية التي يحكمها الناس في تعاملاتهم اليومية.
والقارئ لتاريخ مصر الفاجع في أخريات العهد الملكي، ولو قراءة سطحية، لا بد أن يخرج من تلك القراءة مؤمنًا بأنه كان من المحتم – ما لم يكن المصريون قد ماتوا وتحولوا إلى جثث نخرة – أن «يحدث شيء»، يقع انفجار ما يغيّر الأوضاع اللاإنسانية التي كانت مصر قد انحطّت إليها.
ولكن، أيّ انفجار؟
أناس من تلك الكثرة المظلومة المنتهكة يخرجون إلى الشوارع وينتزعون الحكم بالقوة من السلطة الحاكمة؟ شيء على غرار الثورة الفرنسية، عندما اجتاح باريس الحفاة الذين كان الأرستقراطيون يدعونهم «لي سان كيلوت» – أي الذين لا يستر أعجازهم العارية لباس؟ أم ترى تمارس تلك الكثرة المنتهكة «الثورة» الآن بالوكالة؟
يبدو أن التنظيم المحكم للمجتمعات في هذا العصر بات يجعل من الصعب الذي يقرُب من المستحيل تكرار الهبّات الشعبية التي من قبيل الثورة الفرنسية. وما الذي تظنه كان سيحدث لو كانت بضعة آلاف من المصريين قد خرجت في سنة ١٩٥٢ لتطيح بحكم فاروق؟ في الأغلب، كان رصاص المسلحين سيحصدها، أو تخرج لها جماعة من المسلحين لتقودها إلى الإطاحة بالحكم القائم.
وفي الحالة الأولى، كان الأغلب أن يُقضى على تلك الهبة الشعبية حقيقة؛ لأن الذين كانوا سيقومون بها أناس من تلك الكثرة المظلومة، فيُجهَضون في مهدها. أما في الحالة الثانية، أي خروج جماعة منظمة من المسلحين، عسكريين أو غير عسكريين، لقيادة الهبة الشعبية، فما الذي تظن أنه كان سيحدث؟ هل كان يمكن – حقيقة – أن تدعو الجماعة المسلحة، بعد النجاح فيما قامت به الهبة الشعبية من الإطاحة بالحكم القائم، تلك الكثرة الكثيرة للجلوس معها على مقاعد الحكم الوثيرة مكان المستغلين القدامى الذين أُطيح بهم؟ ذلك لا يحدث، ولم يحدث.
عندما خرج أناس أحرقوا القاهرة في أخريات العهد الملكي، كان يقودهم فاشيست وأشباه فاشيست تطلعوا إلى السلطة ولم تطاولها أيديهم؛ لأنهم لم يكونوا مسلحين ومنظمين بالقدر الكافي.
وكما شبّ الحريق، انطفأ بغير جدوى، اللهم إلا إعلان الرفض لما كان قائمًا من أوضاع، وإعلان الكراهية للمسؤولين عنها.
وتطلّب الأمر ستة أشهر – بعد إقالة حكومة الوفد في ٢٦ يناير ١٩٥٢ – من التخبط الكامل (خمس وزارات وملك خان الثقة والحب اللذين أغرقه فيهما شعبه، فأخذ يعدّ العدّة للهرب بما استطاع من أسلاب وغنائم، وطبقة حاكمة قد طفحت إلى السطح عفوناتها وتفسّخاتها وتناقضاتها العميقة) لم يحدث خلالها شيء، إلا عندما قامت زمرة مسلحة من الجيش بما أُطلق عليه بعد ذلك اسم «الثورة المباركة».
كان من المتعين، إذن، أن يقع التغيير بالوكالة. فالذي قام بالتغيير لم يكن «الشعب الكادح»، الذي يخطو فتخرج الشرر والنار من زحفه العظيم، كما قالت «الأغاني الوطنية» بعد ذلك؛ بل قامت به زمرة من الضباط من أبناء البرجوازية الوسطى والبرجوازية الصغيرة، استغلت اضطراب الأمور في صفوف قيادات الجيش بسبب أزمة حول نادٍ للضباط أو شيء قميء من ذلك القبيل، فبادرت واغتنمت الفرصة، وبضع مركبات مسلحة، وقدر كبير من الفوضى والاضطراب، وحُسن الحظ لأفرادها، فوجهت رصاصة الرحمة إلى نظام محتضر.
فالذي حدث لم يكن «ثورة» بالمعنى الذي يقول به منظّرو الثورات الماركسيين في هذا العصر المخمور بالماركسية، ولم يكن ثورة بالمعنى الذي نستقرئه في تواريخ الثورات التي من نوع الثورة الفرنسية مثلًا، بل ولم يكن ثورة كثورة ١٩١٩ المصرية المسكينة التي اندثر ذكرها.
كان انقضاضًا على وضعٍ بات يحتم تغيير ما كان قائمًا، واغتنامًا لذلك الوضع، وإحلال حكام جدد محل الحكام القدامى، كان كل اختلافهم عن أسلافهم قولهم إنهم جاءوا ممثلين للشعب الكادح، ومن أجل رفع الظلم عن أهله.
لم يشترك عامل في المراكز الصناعية الكبرى كالمحلة وكفر الدوار وغيرهما في تلك الثورة، بل استهلّت الثورة المباركة نشاطها بشنق العمال في مصانع كفر الدوار.
ولم يشترك فلاح بقرى مصر في تلك الثورة، ولم ينقضّ جندي واحد على أسياده الطبقيين في الجيش فيذبحهم؛ بل تحرك عدد من الضباط وأصدر عددًا من الأوامر، واستغلّ ارتباك القيادات وتفسّخ الضبط والربط، فأحدث شوشرة مسلحة صادفها حسن الحظ فنجحت، وأسقطت نظامًا كان كالبيت الخَرِب الآيل إلى السقوط.
كانت ثورة حضرية، عاصمية تمامًا، عسكرية صِرف، لم يشترك فيها ولو حضري مدني واحد، اللهم بالهتاف فيما بعد.
وعندما جاء الثوار الأبرار إلى مقاعد الحكم، التي ولّت عنها الجرذان القديمة العفنة التي كانت متربعة عليها، لم يكن مجيؤهم بناءً على فكرٍ ثوري متكامل أو نصف متكامل، أو فكرٍ موجود أصلًا؛ بل كان مجيئًا ارتجاليًا و«لعبًا بالسماع». كانت ثورةً بغير خطة، بغير عقيدة، إلا الوصول إلى الحكم، وإحداث التغيير... أي تغيير؟ وفي أي اتجاه؟ وبأي وسيلة؟ لم يدّعِ أحدٌ أن أحدًا كان يعرف. كانت خليطًا من تطلعاتٍ مبهمة، وآمالٍ غير واضحة المعالم، ومصالح غير متجانسة، تشهد بذلك الخلافات الحادّة والعميقة التي نشبت بين القائمين بها بعد أن استتب لهم الأمر.
كانت – كثورات العالم الثالث – التي ينقلب فيها المسلّحون من حماةٍ لبلدهم ضد العدوان الخارجي إلى جيشٍ مهاجمٍ يستولي على ذلك البلد كغنيمة حرب، عمليةَ استيلاء. ولما كان ذلك قد حدث، بات من المتعيّن على الشعب الكادح أن يواصل الكدحَ بدأبٍ وإصرار، ويخلد إلى السكينة، تاركًا لزمرة الأبرار من أبنائه الفرصة للعمل بهدوءٍ لإصلاح ما فسد من شؤون البلد.
وبطبيعة الحال، لم يخطر ببال أحد أن يسأل ذلك الشعب عن أولويات ذلك الإصلاح، أو يأخذ رأي أغلبية المصريين في الاتجاه الذي ينبغي أن يسير فيه التغيير؛ لأنه ما دام الشعب قد وكّل زمرة الأبرار (بغير توقفٍ وإضاعة وقت) – عند أشياء كنَوعية ومشروعية مثل ذلك التوكيل – الذي اعتُبر قضيةً مُسلَّمًا بها، فلا شكّ أنه لا مانع لديه في أن يقرّر أبناؤه الثوار الأبرار فيما بعد، نيابةً عنه، عندما يتسع الوقت، أولويات الإصلاح وأسبقياته، ونوع الإصلاح، ولونه، واتجاهه.
وقبل أن ينقضي وقتٌ طويل، كانت الزمرة التي قامت بالثورة المباركة قد ترسّخت، وتحجّرت، وبانت كنظام حكمٍ جديد، له أذنابٌ وتوابع وذيول وأطراف من كتبة الدواوين الذين يخدمون في كل عهد، وكلاب الحراسة الشرسة التي تؤجّر مسدساتها وخناجرها وسياطها لكل من تربع على مقاعد السلطة، بل وبعض السياسيين القدامى الذين انقلبوا «ثوريين».
وأُقيمت محاكم التطهير للتخلّص من عدد من رؤوس أُخطبوط الجهاز البيروقراطي التي اكتشف النظام الجديد أنها يمكن أن تكون مزعجة له، ولتقديم عددٍ من المدنيين إلى ذلك الشيء الذي يدعونه «محكمة الرأي العام». كما أُلغي – بضجةٍ إعلامية كبيرة – البوليس السياسي، جهاز القمع والأمن الذي كان النظام السابق يركن إليه في عملياته القذرة، وأُفرج عن السجناء السياسيين، لكن الجهاز البيروقراطي ظل قائمًا؛ بل ازداد ضراوةً ومنعة. وفي مكان البوليس السياسي، تكاثرت الأجهزة «لحماية مكاسب الشعب الكادح»، وتكاثرت معسكرات الاعتقال.
ترسّخ الحكام الجدد مكان الحكام القدامى، وأقاموا متاريسهم واستحكاماتهم، وأقبية تعذيبهم، ومحاكمهم الصورية، باسم الشعب، ومن أجل الشعب.
حدث ما حدث، ويحدث كل يوم في آسيا، وأفريقيا، وأميركا اللاتينية، وبات الثوار الأبرار حكامًا وسادة مسؤولين، متحصّنين وراء بنادق ومدافع ودبابات جيشٍ تحوّل إلى جيش احتلال داخلي، وبدأ يُدرك أن بوسعه – بغير خشيةٍ أو تورعٍ أو حرج – أن يُعامل بلده باعتباره غنيمة حرب كسبها في معركة، وبات من حقه أن يتمتّع بها، وهو محتمٍ بأقبية التعذيب، وأسوار الأسلاك الشائكة، وسياط ومعدات الحشرات السامة المريضة التي تسرح دائمًا في أجساد الأنظمة، وتتسمى بأسماء رنانة تنتمي إلى مفهوم «الحماية» – حماية المجتمع من أعدائه – وإلى اسم العدالة، ومفاهيم القانون والنظام: المباحث، المخابرات، أمن الدولة، إلى آخر تلك المسميات.
مشهد جيفارا وثورة كوبا
وعلى ضوء ذلك، ألا يكون قرار جيفارا، بعد نجاح «ثورة» كاسترو واستقرار الأمور في كوبا، أن يترك «المنصب» ويذهب ليشعل ثورة جديدة يموت فيها، ألا يكون ذلك القرار الشريف تجسيدًا لنموذجٍ مأساوي يليق بذلك الواقع الثوري المُرّ، ورفضًا – لعله أشرف ما أقدم عليه ثائر في عصر البغاء السياسي هذا – لغواية الانزلاق المريح المربح في الرمال المتحركة التي يمثلها التسليم بذلك الواقع؟ ولِمَ يظل جيفارا نظيفًا ووضيئًا ومشرقًا، ومن وجهٍ ما: غريبًا؟
أليس لأنه – باختياره أن يظل مقاتلًا وثائرًا، ورفضه الوقوع في براثن غواية التحول إلى جزء من نظامٍ تحجّر وبات مما يتعيّن أن يثور الثائر الحقيقي عليه، وامتناعه عن الانقلاب إلى إلهٍ من تلك الآلهة الأميرية الصفيقة التي يعبدها الرعايا في عصر محاكم التفتيش الجديد هذا، ودفعه حياته ذاتها ثمنًا لاختياره ورفضه – قد جعل لـ«الثورة» معنى، وأعطاها مبررًا أخلاقيًا وإنسانيًا، وطهّرها من الدنس البراجماتي الواقعي، الذي بات ملازمًا لها حتى أوشك أن يجعلها لفظة بذيئة
أليس لأنه – باختياره أن يظل ثائرًا بدلًا من أن يجلس ويستريح ويحصي أرباحه وغنائمه – قد جعل من الثورة شيئًا آخر نظيفًا، غير ذلك الشيء الذي يطيح بفئةٍ جالسةٍ متربعةٍ مرتاحةٍ، ليأتي بفئةٍ ظمأى مشتاقة، فيُجلسها حيث كانت سابقتها لتشبع وترتاح، وهي قاعدة فوق نفس الوجوه النعسة الغبية المسكينة، سريعة التصديق، سهلة الانقياد، التي لم تَفِد من التغيير شيئًا إلا تغيّر الأعجاز الغليظة الجالسة فوقها؟
أليس لأنه – جيفارا ذاك – برفضه وجنونه، نكص عن ممارسة لعبة «النظام – الثورة – النظام» المعاصرة، ورفض أن يخدع ملايين الفقراء الجياع المظلومين المنتهكين المستعبدين المستغَلّين، المحاصرين بين بنادق المجرمين الأميريين، وبنادق قطاع الطرق الذين لا يفعلون – في الحقيقة – شيئًا إلا منافسة الحكّام على الغنائم، ووعود الكنيسة الكاثوليكية بأنه لا ضير، يا أبناء الله، في القبول بالعذاب والامتثال له في هذا العالم الفاني، انتظارًا للثواب الأعظم فيما بعد، في العالم الباقي؟
ولم يقبل بأن يركب أولئك البائسين مطايا إلى السلطة، ويطردهم متى أوصلوه إليها، كغيره، آمرًا إياهم بالعودة – في نظامٍ وهدوءٍ وأدب – إلى حظائرهم الأبدية، ولم ينقلب عليهم كوحشٍ ضارٍ، ولا نهشهم باعتبار أنهم قد ورثوا له خرافًا ونعاجًا وأبقارًا، وانتقلوا من خلال الثورة المباركة، من مزرعة السادة القدامى إلى مزرعة السادة الجدد، الذين سرقوا غضبهم واغتصبوا عذابهم وركبوا حلمهم بحياةٍ إنسانيةٍ سوية ينبغي أن تكون حقًا أساسيًا لكل إنسان؟
أليس لأنه – تشي جيفارا – اختار أن يظل حتى النهاية في صف تلك الملايين الكثيرة التي تُرتكب كل الجرائم باسمها، كمقاتلٍ في تلك الصفوف، واختار – بدلًا من السلطة التي وصل إليها – أن يشارك تلك الملايين الشقاء والمخاطر، ويُعلّمها «كيف تقاتل، وكيف تموت، ربما، كما مات هو» دفاعًا عن آدميتها، بدلًا من أن يشارك في اقتنائها كقطعان، أو كأرقام قابلة للاستهلاك والاستبدال؟
أليس لذلك، ولا شيء غيره، مات تشي جيفارا ميتته الشريفة؛ لأنها كانت تطهّرًا من الكذب والغش، أملًا جديدًا لشباب هذا العصر، ضائع الأوهام، فاقد الأمل، وكل الحالمين بالعدل من أجل البشر، لا بالسطوة والغنائم للكلاب التي تحوّلت إلى ذئابٍ مسعورة؟
المواجهة الفكرية مع الرد الأيديولوجي على أمثال جيفارا، وأسئلة المصير
والرد جاهز – أيديولوجيًا – على مثل هذه الرؤى، وهو ردّ فصيح ومُجرّب. فحكاية «الثورة الدائمة» هذه حلم شاعري، وما هذا الذي فعله المناضل جيفارا إلا مجرد تحرك تكتيكي، وتطبيق عملي للوعي الثوري، القائل بأنه لا سبيل إلى تحقق الحرية، والسعادة، والعدل، والتحرر من استغلال الشعب من الشعوب، أو بالأحرى الطبقة من طبقات الشعوب، إلا متى عمّت الثورة العالم بأسره، وقضت على كل جيوب ومعاقل الاستعباد والظلم والاستغلال في العالم كله.
وإلى أن يتم تطهير العالم الواسع العريض من تلك المعاقل والجيوب (وهي كثيرة وضارية)، ما على الشعب من الشعوب إلا أن يمتثل لحكم الضرورة، ويستسلم، ويؤمن بالتاريخ، أي يظل شعبًا من الخراف، والنعاج، والسبايا، وأسرى الحرب بغير حرب، للكلاب الشرسة المسلحة التي تحوّلت إلى كتّاب؛ لأن من تنتهكهم وتفترسهم عزّل ويتصورون أنها أبناء وأخوة لهم، وكتبة الدواوين، وعُباد العادات من مدّعي الألوهة.
وفيما بعد، فيما بعد، عندما يكون قد تم القضاء على كل الأشرار والمستغلين في كل ركن، وجحر، ووكر، في هذا العالم، سيُصبح بوسع الناس (أو السادة المواطنين) أن يستردوا الحرية، وينعموا بالعدل، ويرتعوا في رياض المحبة، ويُبعثوا بشرًا أحياء من جديد، بقدرة التاريخ.
تلك هي الواقعية الثورية بحق، ولا مجال في ذلك كله للخداع، لا خداع النفس ولا خداع الآخرين، ولا الانقياد وراء الأوهام؛ فالبروليتاريا أول طبقة في التاريخ حُرّرت من كل الأوهام. وهي – لذلك – ليست بحاجة إلى خداع النفس؛ لأن المسار الموضوعي للتاريخ لا ولن يتعارض مع مصالحها وأهدافها؛ بل هو – على العكس – متجه إلى تحقيقها.
وليست تلك الطبقة بحاجة إلى خداع الآخرين؛ لأنها لا تتطلع إلى مزايا تكسبها لنفسها على حساب غيرها من العمال، فالطبقة العاملة تعلم جيدًا أنها لن تستطيع أن تحرر نفسها بغير أن تحرر سائر البشر جميعًا، وتقضي قضاءً مبرمًا، نهائيًا، وشاملًا، على كل صور وأشكال وفرص استغلال الإنسان لأخيه الإنسان.
وتلك غاية نبيلة، ومقصد شريف، ما في ذلك شك؛ فقضية الإنسانية واحدة، لا تتجزأ، فيما يخص الحرية، والعدل، وسائر تلك القيم الأخلاقية الإنسانية العليا، لسبب بسيط، هو أن البشر – بغير حرية – يتحولون إلى وحوش.
ماذا حدث للألمان، الشعب المتحضّر العريق، عندما أطلّ عليه هتلر بوجهه القبيح، وجرّده من الحرية؟ تحول إلى شعب من وحوش، أو – إن أردنا الصدق – ارتدّ شعبًا من وحوش؛ فالبشر فيهم تلك الوحشية القديمة قدم الجبال، التي تروّضها الحضارة، وتتعهدها الحرية (والحرية ليست إلا المحصلة النهائية لكل ما يفصل الإنسان عن البهيمة)، فتجعل من الممكن للبشر أن يتعايشوا دون أن ينهش بعضهم بعضًا، في إطار من علاقات يحكمها القانون، وتسوسها الأخلاق. وبغير الحرية، تفسد الحضارة، وترتخي قبضتها على وحشية الإنسان، بل وقد يصل فسادها – كما يحدث لها في ظل النظم الشمولية – إلى حد تشجيع تلك الوحشية وإطلاق العنان لها.
ولدينا الدليل في تواريخ الأمم: لم توجد أمة خضعت للطغيان، وتنازلت عن الحرية، أو جُردت منها، إلا وتحولت إلى قطيع مستوحش، خارجٍ على الإنسانية.
والعالم – في عصرنا بالذات – قد بات أضيق وأصغر من أن يتيح لشعب بعينه، أو مجموعة من الشعوب، أن تتعايش تعايش البشر، مع شعبٍ أو شعوب أخرى، قد حوّلتها الشمولية والمظالم وانتفاء الحرية إلى كواسر وضوارٍ وأشباه بشر.
نعم، قضية الحرية والعدل واحدة، لا تتجزأ. ولكن من قال إن الحرية والعدل أشياء يمكن أن تؤجَّل إلى ما بعد؟ إن كل جيل من أجيال البشر يعيش «هنا» و«الآن»، وليس «هناك» و«فيما بعد».
التساؤلات حول الثمن المؤجل والحرية المؤجلة
كل جيل له لحظته، السريعة الانقضاء، ولا وجود له إلا فيها، فكيف يتأتى – باسم الحرية والعدل – أن تُرغم، أو تُستدرج أجيال وراء أجيال من البشر إلى التنازل عن الحرية، والعدل، وسائر مقومات الإنسانية، على وعدٍ بأن تستردها «فيما بعد، عندما تستقيم الأمور»، أو كثمن تدفعه في سبيل أن تتمتع أجيال أخرى مقبلة بالحرية والعدل، بعد أن يكون قد اكتمل تحرير البشر جميعًا في كل مكان، والقضاء على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان؟ أو تلك التي تقبل بالتضحية بحريتها في سبيل أن تتمتع بها أجيال مقبلة؟
من ذا الذي يضمن لتلك الأجيال المتنازلة، المضحية، المُضحّى بها، أن تضحياتها لن تذهب هباءً؟ وأنها، والأجيال المقبلة في الآتي من الزمان، لن تغنم من وراء تلك التضحيات الجسيمة شيئًا إلا تأييد الظلم، وتأييد الاستغلال، وتأبيد الطغيان والاستعباد، وترسيخها، وتأصيلها، وجعلها طريقة حياة تقبلها كل الأجيال، وتُعلِّم بمشروعيتها، انتظارًا لتحقق ذلك الوعد الأبدي بالخلاص منها، في «فيما بعد»... في تلك النقطة الافتراضية، التي تنسحب أمام كل جيل آتٍ، متراجعة إلى موقعها هناك، في الأفق البعيد، أو تسليمها بـ«أن الأمر كان هكذا دائمًا»؟
من ذا الذي يضمن للأجيال المؤمنة، النبيلة، القابلة بقدرها، من أجيال شعبنا الطيب، أو أي «شعب طيب» آخر، أن الذين تتنازل لهم طواعية، وتصديقًا للموعود، أو تتركهم يُجرّدونها من آدميتها، ابتغاءً للأمان، واتقاءً لشرّهم، لن يخدعوها؟ لن يبيعوها؟ لن يُفسقوا فيها، ويُجرّدوها من كل شيء؟ فتكون – بتضحياتها، وامتثالها، وخضوعها – قد حكمت على نفسها، وعلى كل الأجيال القادمة، بأن تتحول إلى قطعان تُباع، وتُشترى، وتُذبح، وتُمتطى، في بلدانها التي كانت أوطانًا لها، فتحولت من خلال تنازلها عن حريتها، ومقومات آدميتها، إلى مزارع لحكّامها، وقادتها، وزعمائها، وأتباعهم، وأذنابهم، وحشراتهم السامة؟
نعم، الاستغلال بشع، الظلم فظيع، وانتهاك الإنسان، وحرمانه من الحرية، وتجويعه، وإذلاله، ومنعه من ممارسة آدميته، أشياء لا تُطاق. ولكن... ما القول في الغش، والخديعة، والكذب؟ ما القول في سرقة الأمل من صدور المظلومين، وتحويله إلى أغلال توضع حول رقابهم، وتُكبّل أيديهم وأرجلهم، وتُكمّم أفواههم، وتُعطّل عقولهم؟
آه... إن أي نظام يفعل ذلك، نظام مرتدٌّ غير ثوري، وتتعين الثورة عليه من جديد، إنقاذًا للثورة من ردّته، وانحرافه، وتشويهه لها. أي: الثورة الدائمة، المتجددة، المستمرة، المتواصلة، التي لا تنقطع… ثورة جيفارا.
ولكن، بصرف النظر عن التساؤل، الذي قد يكون له ما يُبرره: «وأي شعب بطل بطولة هيرقلية ذاك، الذي يظل يخيب أمله، فيثور مجددًا، المرة تلو المرة تلو المرة، بلا انقطاع، حتى يُطهِّر ثورته من كل غش وخديعة وكذب؟»
بصرف النظر عن ذلك التساؤل، الذي قد يكون جوابه المقنع المقبول: «كل شعب أراد أن يعيش حرًّا، وبمنجاة من الظلم والاستعباد»، أو قد يكون جوابه الحالم: الشعب الذي يتجه إلى «إقامة الدولة في حدّها الأدنى»... بصرف النظر عن هذا التساؤل، والأجوبة العديدة الممكنة عليه...
ما القول في النظم، إذ ترسخ وتقعد على صدور المحكومين، الذين جاءت إلى السلطة بادّعاء أنها جاءت لتحريرهم من الظلم والاستغلال، فتُؤيّد ظلمها واستغلالها لهم بسرقة شعار الثورة الدائمة، وتحويله إلى شعار: الثورة مستمرة؟ والادّعاء بأن النظام الحاكم ما زال مجتهدًا غاية الاجتهاد في تحقيق التغيير، وأن الأمر يتطلب وقتًا، وجهدًا، وعرقًا، وكفاحًا، مما يقتضي أن يظل المحكومون، أو «السادة المواطنون»، مخلّدين إلى الهدوء، والاستكانة، واللوذ بشقوقهم وجحورهم، لإعطاء الفرصة للحكّام، من خلال استمرارية «الثورة المباركة»؟
وقتها، يكون الشعب من الشعوب قد وقع في الفخ تمامًا، وأحكمت الحية حول عنقه، فبات رهينة، وأسير حرب في أيدي حكامه وأتباعهم المسلحين، ويتعيّن عليه أن ينتظر أجيالًا بأكملها، على أمل أن تؤدي تناقضات النظام الحاكم إلى تفسخه وانحلاله، كما اضطرّ الشعب الإسباني إلى الامتثال طيلة أربعين عامًا أو أكثر، قبل أن ينزاح عن كاهله وجه فرانكو البشع.
وحتى وقتها، لا تكون نجاة للشعب المبتلى؛ لأن كل تلك العقود الطويلة من الاستعباد والحكم الشمولي تكون قد رسّخت في بنيته سرطاناتٍ تظل تنهش جسده، وتدفعه إلى الانتكاس. ففرانكو ترك سرطانه الفاشي في جسد إسبانيا، وموسوليني ترك سرطانه الفاشي في جسد إيطاليا، وستالين ترك سرطانه الشمولي في جسد روسيا.
هذا عالم فظيع إذن؛ عالم يبدو كما لو كان لا خيار فيه إلا القبول بظلمٍ أو بآخر، والامتثال لعبوديةٍ أو لأخرى. ولِمَ يجب أن يكون استغلال الملايين وظلمها وامتطاؤها باسم «الأجيال القادمة» قدرًا محتومًا بحكم التاريخ؟ تمامًا كما يُقال لها إنه «قدر مفروض من السماء»؟ ولِمَ يتعيّن على تلك الجماهير أن تمتثل، وتتنازل، انتظارًا لمجيء «الفردوس الأرضي» في آخر التاريخ؟ تمامًا كما يتعيّن عليها أن تمتثل وتتنازل، انتظارًا لفرصة دخول «الفردوس السماوي» في آخر الزمان؟
لكن هذا الذي نقوله كلّه هراء، أولًا: لأننا نُغفل دور الجماهير، ونُفكّر كما لو كانت تلك الجماهير خرافًا طيّعة. وثانيًا: لأننا نُغفل التفاعل الحتمي لكل تلك القوانين الموضوعية للتاريخ، التي لا تهدأ لحظة. وثالثًا: لأنه… ما وجه الشبه بين «الثوار الأبرار»، أو «الطليعة الثورية» التي تقود الجماهير إلى التحرر من الاستغلال، والعبودية، والظلم… وأولئك الطغاة والرجعيين، الذين يجدعون الجماهير، ويقودونها من خطمها، وهي مخدَّرة بأفيونها المفضل، إلى مزيد من الاستغلال، والعبودية، والظلم؟
ولئلا نكون ظالمين: ليس الكل كَلْبيين. ليس الكل وحوشًا، وأهل تزييف، وغش، وخداع. هناك أصحاب رؤى ومبادئ. غير أن المشكلة أن أصحاب الرؤى أثبتوا دائمًا – بالبرهان الدموي – أنهم أفظع… بالحقيقة: أفظع. روبسبيير، جزار الثورة الفرنسية، ممن استمدّ فكره ورؤاه من جان جاك روسو. وعندما بات طليعةً ثوريةً للشعب الفرنسي، اعتقد اعتقادًا جازمًا بأنه «جاء كمشرّع»، و«تجسيد للإرادة العامة»، فكان أن أقام هو وسان جوست ديكتاتورية أغرقت فرنسا في بحر من الدماء.
ومارا، وهو «نجم ثوري» آخر من نجوم الثورة الفرنسية، ماذا كان؟ كان طبيبًا يعالج الناس، وصحفيًا رأس تحرير صحيفة «صديق الشعب»، التي هاجمت السلطة وطغيانها قبل الثورة هجومًا لا هوادة فيه، وظلّت تتحدث بغير انقطاع عن الحرية، والمبادئ، وحقوق الشعب الفرنسي… إلى أن جاء مارا إلى السلطة، وانضمّ للعقبة، فأقام ديكتاتورية رهيبة، اعتبرت نفسها مسؤولة عن إقامة مهرجان من المذابح في سجون فرنسا. ولا يكفّ مارا عن وحشيّته المسعورة، إلا عندما ذبحته في الحمام الفتاة الفرنسية – ابنة الخمسة والعشرين ربيعًا – شارلوت كورداي.
وستالين؟ ألم يكن من أصحاب المبادئ والرؤى؟ كم من الروس ذبَح؟ القائمة طويلة، ومخصبة بالدم، بل غارقة في الدم.
فلمَ يتحوّل منقذو العالم دائمًا إلى سفاحين وقتلة، يُغرقون الدنيا من حوفم في دماء الضحايا، المرة تلو الأخرى؟ فيما يبدو لنا: لأنهم – المنقذون – أصحاب رؤى، يقومون – عن وعيٍ وقصد، أو عن غير قصد – بدور الآفة.
ألا يأخذ الواحد منهم على عاتقه مهمة تفكيك العالم، وإعادة تركيبه، على الصورة التي يرى أن ذلك العالم يجب أن يكون عليها؟ وقد تكون الرؤية رائعة حقًا، ونبيلة حقًا، وسامقة، لكن الآلهة لديها وقت… لديها أبدية لا نهاية لها، تُغيّر خلالها، وتُبدّل، وتُعيد، وتزيد، وتخلق من جديد، أو تمحو اللوح محوًا، وتبدأ من نقطة الصفر.
أما الآلهة من أصحاب الرؤى الأرضيين، فلا يحتكمون – لسوء حظ البشرية – في كل ذلك القدر الكبير المهول من الوقت المتاح للآلهة. العُمر قصير ومحدود، وليس هناك وقت. وسنواتهم المحدودة على ظهر هذه الأرض لا تتيح لأيٍّ منهم أن يُعيد خلق العالم على صورته، ليبيت العالم مطابقًا لرؤيته، خاصة وأن كل تلك الملايين من البشر المتعبين، تَرهق العالم وتُربك أصحاب الرؤى، وتدخل في شعرهم، وتُعوق تنفيذ الرؤية أو الحلم، بكلها، وبلادتها، وصغر أحلامها، ومشاكلها التي لا تنتهي، وبطونها التي لا تشبع، ومخاوفها، وحرونتها.
المأساة الكبرى: الزعيم الذي يختار التضحية بالملايين بدلًا من التضحية بالرؤية
وهكذا يجد «الإله الأرضي»، الزعيم صاحب الرؤى، نفسه مواجهًا بخيارٍ صعب: إما أن يُضحّي بالرؤية والحلم، ودور الإله الذي يُعيد خلق العالم على صورته، في سبيل الملايين، وإما أن يُضحّي بالملايين في سبيل الحلم، فيسوطها، ويعتقلها، ويغسل أدمغتها، ويدخلها معه في معمله، ليُخلّصها من الشوائب، ويخلّص نفسه ممن لا يُرجى إصلاحهم منها، ويعيد صياغة الباقين الذين يستسلمون – تحت وطأة الرعب – ويمتثلون، وبذا يكون الزعيم – الإله – قد غيّر العالم والناس معًا.
وذلك ما يكتشفه كل الآلهة – مهما كانوا مؤمنين، ومتدينين، ويخشون غضب الواحد القهار – أن عليهم أن يفعلوه؛ بل ويكتشف البعض منهم – آلهة العصر – أن الأوفق، والأصح، فيما يخص رؤيتهم لما ينبغي أن يكون عليه العالم، أن يُمحى اللوح محوًا، ويبدأ من نقطة الصفر، تشبّهًا بالله، حين أغرق العالم في الطوفان.
فرؤى هذه السلالة من السادة الرؤساء، أو الغزاة من الداخل، الذين يُصوِّر لهم جبن الآخرين وخنوعهم أنهم من سلالة الآلهة حقًا، تجرّ في أعقابها المذابح، والمعتقلات، وغرف التعذيب، والرعب، والإرهاب، بلا مهرب، ومع كل دفعة – أو وجبة – جديدة تُفترَس، وتُعدَم، أو تُسجَن، أو تُجرّد بالتعذيب من آدميّتها، وتُكسر ظهورها، ينظر «الإله» من تلك الآلهة أمامه بصبرٍ نافد، ليرى كم من الفراسخ قرّبته تلك الوجبة من تحقيق رؤيته، لكنه – لسوء حظ السادة المواطنين – يجد الرؤية كسَرابٍ تنسحب أبدًا إلى مرمى البصر، لا تطاولها اليد التي غرقت في دماء الضحايا، اشتهاءً لتحققها.
وللفور، يُدرك أن عليه افتراس وجبات أخرى من أولئك «السادة المواطنين»، يلحقها بسابقاتها، لأنها – فيما يبدو له – تقف بينه وبين رؤيته النورانية لما ينبغي أن يكون. ويتحول الطوفان، الذي تحكي عنه الكتب المقدسة، إلى طوفانٍ من دماء الضحايا.
ولا جدوى من الهمهمة بأن المسألة ليست مسألة إراداتٍ فردية، بل «مسألة قوانين موضوعية» وما إلى ذلك من سفسطاتٍ بارعة؛ لأن تلك الهمهمة – كيما تثبت مشروعيتها، وغير مكذوبة – ينبغي أن تُفسّر أولًا كيف أمكن أن تظل تلك القوانين الموضوعية تختل، وتلتوي، المرة تلو الأخرى، وتنسحب بفعاليتها التاريخية السرمدية الضرورية المحتومة، تاركةً مئات الملايين من السادة المواطنين، في مختلف أركان المعمورة، ضحايا عزّل، بين أنياب الطيبين الأبرار، وثُوّارهم الأطهار؟
وإن كان ذلك ما يحدث للبشر متى كان «الإله / الزعيم»، الآخذ في تغيير القبيح، العالم، مُخلِصًا، ونبيلًا، وصاحب رؤية، فما بالك إذا كان ذلك الزعيم المعبود، الذي يقتني الشعب من الشعوب، كلبِيًّا، لئيمًا، لا رؤية لديه إلا صورة وجهه القبيح؟
إن الذي تقوله عذابات الشعوب ومعاناتها في هذا العصر، المزدحم بأدعياء الألوهة من الثائرين، هو أن النتيجة واحدة، سواء كان الزعيم قاتلًا محترفًا، أو قديسًا محترفًا، في الحالتين: النتيجة واحدة.
المذابح، والمظالم، والامتهان، والمعتقلات، وغرف التعذيب، وفِرَق الإعدام.
السبب واضح وبسيط: أنه لا آلهة هناك (على الأرض نعني، لأن السماء فيها – يبدو – قد نفضت يدها من الشعوب الغبية، التي تكفر، وترتد إلى عبادة الأوثان)، ولا أنصاف آلهة هناك.
لا أحد هناك يُعبد، أو يُقدّس، أو يُقال عنه بعد موته: «فقدناك، يا آخر الأنبياء»، أو يُنزّه عن الخطأ، ويُرفع فوق المعارضة والمناقشة والاحتجاج.
ليس هناك من يستحق أن تموت من أجل ألوهيته شعوبٌ بأكملها، أو تُجَرّد من حريّتها ومقومات آدميتها.
ليس هناك، ولم يكن، ولن يكون، إنسانٌ يأكل ويتبرز كغيره من البشر، مهما بلغ من الذكاء، والعبقرية، والنبوغ، والإخلاص، يعلو على الخطأ، ويسمو على ضروب الضعف الإنساني. كل الناس يولدون ويموتون.
ليس هناك آلهة على الأرض.
الله وحده هو المنزه عن الخطأ، والظلم، والطغيان. الله وحده هو الذي يمكن للبشر أن يمتثلوا له؛ لأنه هو الذي صنعهم. والله، لا شأن له بالسياسة.
أما الثائر، أو المنظِّر، أو الزعيم، أو «الرفيق السكرتير العام»، فبشرٌ مثلي ومثلك. ولا ينبغي لشعبٍ يُقدّر مسؤولية الحياة، ويقيم وزنًا لآدميّته، أن يسمح له بأن يتألّه، ويُخيّم بوجهه الصفيق ككابوسٍ أبدي، ليملي على عشرات الملايين من البشر سُعاره.
لا أحد ينبغي أن يُسمح له بأن يتحوّل إلى بؤرة صديد في جسد هذه الأمة أو تلك، تجتذب إليها كل ما بأجساد الشعوب من قيح، يتمثل في المرضى، والمشوّهين، وذوي العاهات عقليًا، ونفسيًا، وعصبيًا، من المجرمين، والشواذ، الذين يحصلون على الإرضاء الشبقي بممارسة القتل والتعذيب، ممن يبيعون خدماتهم للنُّظم، حتى يُمارسوا ضروب شذوذهم، وهم بمأمنٍ من المؤاخذة والعقاب.
ولا أحد ينبغي أن يُسمح له – مهما كان فريدًا، ومُبهرًا، ولا قرين له بين السابقين أو اللاحقين – أن يتحوّل إلى مستنقعٍ عفن في بُنية هذا البلد أو ذاك، يجتذب إليه – في حماية أولئك المرضى والمشوّهين من محترفي القتل والتعذيب – كل أنواع الحشرات والزواحف المتسلقة، من مرتزقة، وطالبي ثراء سريع، وكل الطفيليات، التي تتركز أقصى آمالها في امتصاص دماء شعوبها، تحت جناح «إله»، أو «نصف إله»، أو «آخر الأنبياء».
لكن ذلك هو ما حدث، وظل يحدث؛ فكيف تعطّلت قوانين التاريخ الموضوعية السرمدية؟ وكيف طاوعها ضميرها فسكنت؟ نعم، إن التطبيق الواعي للقوانين الموضوعية للتاريخ بيد الطبقة العاملة، ذلك التطبيق الذي تقول الكتب المعتمدة (حتى لا نقول «المنزلة») إنه يبدأ في ظل النظام الرأسمالي ذاته، يحدث عندما تبيت تلك الطبقة ذات نظرة علمية، وتشكّل حزبًا سياسيًا، فتجمع حولها كل القطاعات العاملة من الشعب، وتقود النضال في الاتجاه الذي تمليه القوانين الموضوعية للرأسمالية ذاتها نحو «التحول الاشتراكي».
نعم، إن الجماهير والملايين لا تستطيع أن تتكدّس كلها في الساحة لتقوم بكل هذا، ويتعيّن أن تأتمن على القيام به «طليعتها الثورية»، من حيث إن الثورة الاجتماعية للبروليتاريا أول ثورة تحقق فيها «الطليعة الثورية» (أي الحزب) الإدراك الواضح للمغزى الموضوعي لأفعالها التاريخية، وتقود نضال الجماهير نحو تحقيق التغيير الثوري.
نعم، كل هذا جميل، ومفعم بالأمل المشعّ نورًا؛ لأنه من ذا الذي يكره التغيير إلى الأحسن والأكثر عدلًا؟ من ذا الذي يريد للحظات الظلم أن تستمر؟ لكن المسألة هي: كيف تُحقق تلك الطليعة الثورية تلك الأشياء التي تعد القوانين الموضوعية للتاريخ الملايين الكادحة بها؟
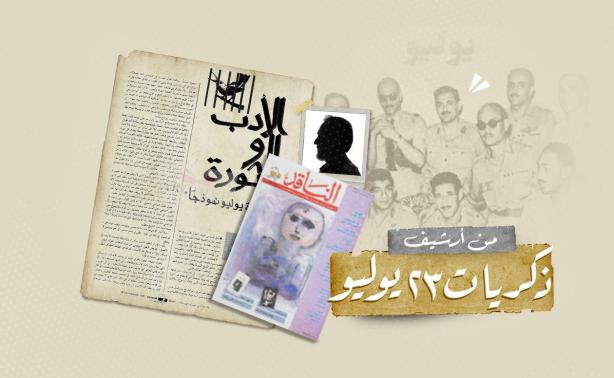 صورة تعبيرية (من أرشيف ذكريات 23 يوليو، مقال للكاتب شفيق مقار نُشر في 1 أكتوبر 1988 بمجلة الناقد)
صورة تعبيرية (من أرشيف ذكريات 23 يوليو، مقال للكاتب شفيق مقار نُشر في 1 أكتوبر 1988 بمجلة الناقد)